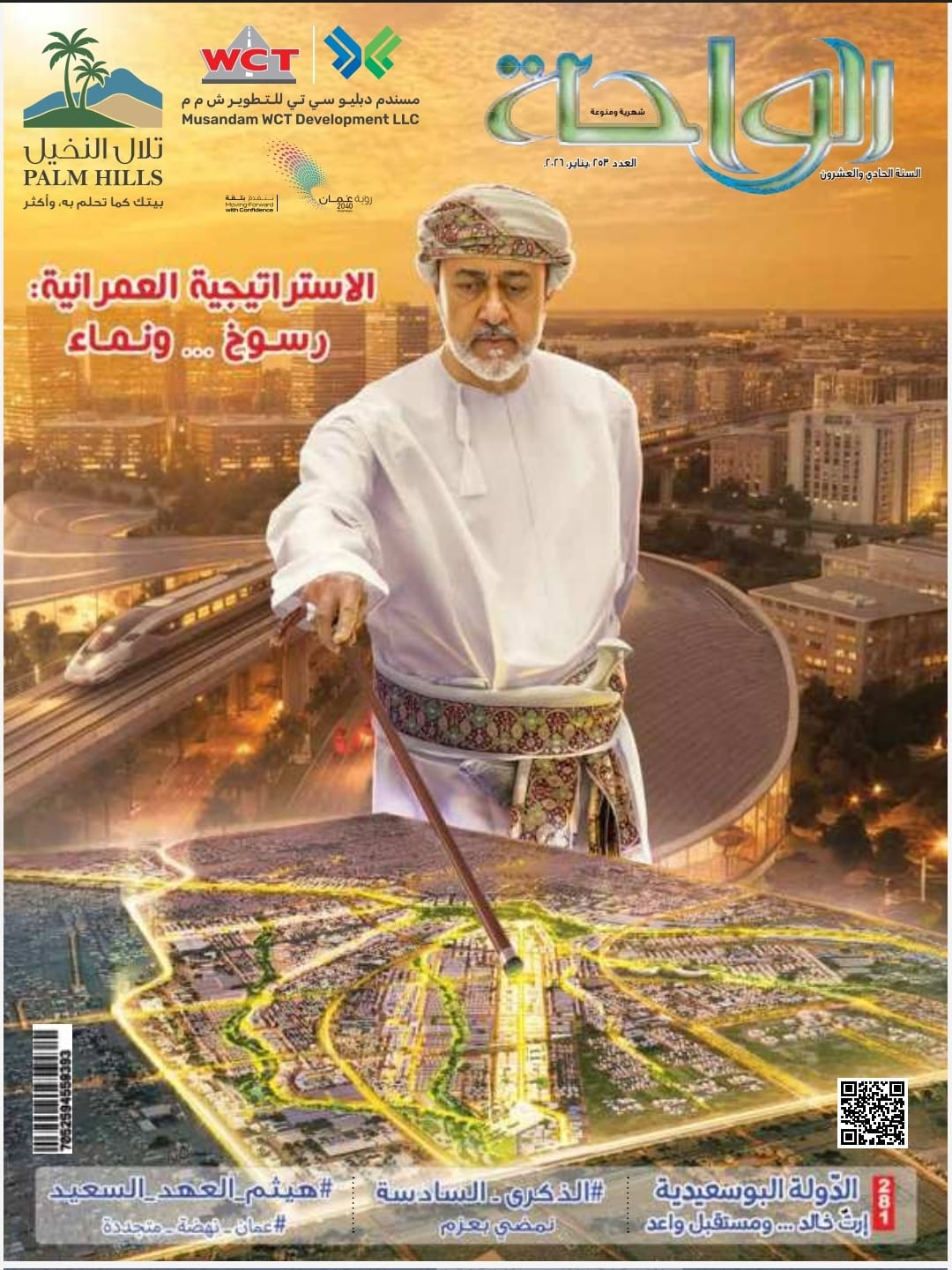حمود بن سيف الشكيري الواقف على ثغور الذاكرة

محمد بن عامر العيسري
كاتب وباحث في التاريخ
لئن كانت شمس الخامس والعشرين من رجب سنة ١٤٤٧هـ قد أشرقت في إبرا على خبر رحيل الوالد المعلم حمود بن سيف الشكيري، فهي ذاتها الآفلة يوم رحيل أبيه المعلم سيف بن سعيد الشكيري في السادس والعشرين من رمضان سنة ١٤١٣هـ، وكأن القَدَر أن يتجاوز الأب وشبله التسعين من العمر في رحلة طويلة تقاسما فيها حُلو العَيش ومُرَّه، واجتمعا في شرف المهنة. حكى لي المعلم حمود أنه وُلِد في بلدة سومباوانجا من البر الإفريقي سنة ١٣٤٨هـ بعد أن هاجر أبوه إليها، لكنه ما لبث أن عاد إلى وطنه سنه ١٣٥٠هـ وبذلك يكون عمر المعلم حمود حينذاك سنتين فحسب، كما حكى أن أباه عاش ثلاثًا وتسعين سنة، ثم كان من قَدَر الله أن يعيش هو تسعًا وتسعين، والآجال بيد الله مكتوبة لا يُقدِّمها حِرص ولا يؤخرها حَذَر.
ولا يكاد ينفكّ ذكر الأب عن حديث الابن، فمن “حصن الدغشة” تخرَّج المعلم سيف، وفي حضرة القُضاة والولاة: سليمان بن سنان العلوي، وسيف بن حمد الأغبري، وسليمان بن حامد البراشدي جلس واستمع وتردد بين الجامع و”مسجد الجفيرة” و”بيت المسارير” و”مسجد القناطر”، وبين أزقّة “الصفح” و”الدغشة” و”المقطورة” سارت خطاه، ومن ظِلال “المستريحة” خَرّج المئات عبر أجيال متعاقبة ممن تعلموا القرآن الكريم والخط على يديه.
وإذا كانت تلك اللحظة من التاريخ في مدرسة “المستريحة” قد رصدتها عدسة “دونالد هولي” أول سفير بريطاني في عمان، ثم تلتها عدسة الباحث الفرنسي “باول بوننفان” فإن ذاكرة المعلم سيف وتجليات هيئته وهيبته ومصحفه وعصاه قد رسخت في أذهان أجيال من التلاميذ السائرين في درب “المستريحة” وهي “السبلة” و”الكارجة” و”المدرسة” في آنٍ معًا. على أن لحظة أخرى من ذاكرة إبرا كانت من صيد عدسة المصوِّر تغلب بن هلال البرواني، والمعلم سيف شاخص يخطب في الناس لصلاة العيد، بعد أن أسبغوا الوضوء من شرح “فلج الصغيَّر” حتى غدت صُوَر المعلم سيف أول ما ينصرف إليه الذهن من ذاكرة إبرا المصورة. وحين نُقَلِّب دفاتر المعلم سيف التي قَيَّد فيها كل دقيقة وجليلة من أعماله في أموال أوقاف المساجد تتسابق إلى الذهن معاني الإخلاص والأمانة، وتتراءى في سطورها سمات الضبط والدقة.
ولا غرو أن يكون المعلم حمود بن سيف “على ما كان عَوَّدَهُ أبُوه” فقد كان الظِّل والساعد حيثما يمّمَ والده الشطر، ففي حضنه تربّى وفي مدرسته تعلّم، ثم كان قَدَرُه أن يكون هو الآخر مُعَلِّمًا. وعندما أُوكِلت مهمة أموال الأوقاف إلى أبيه في نحو سنة ١٣٧٠هـ خَلَفًا للقاضي البراشدي انطلقت حينها دورة أخرى لَبِث فيها المعلم حمود سنين طويلة من التعلُّم والتدريب، فقد رافق أباه مساعدًا له في ضبط أموال الوقف والإشراف عليها والكتابة والتوثيق والعِمار، ثم كُتِب له أن يخلف أباه في تلك المهمة الجليلة. ومن حيث يشعر المعلم حمود أو أنه لا يستشعر فقد سبر أغوار جغرافية سُفالة إبرا بأفلاجها وبساتينها وقُراها ومواضعها، فلا تكاد تسأله عن دقيق كل ذلك وجليله إلا أجابك، حتى أنه لَيَتصوَّر كل بقعة وما يحدُّها من الجهات الأربع، ناهيك عما ضَمَّه صدره من ذاكرة في شأن الأملاك من الأموال الخضراء والرموم ومياه الأفلاج حتى غدا في ذلك مرجعًا لا يُستغنى عنه حتى أخريات أيام حياته. ومن عجيب ما حكاه لي ذات يوم في وصف رجل من أهل المنزفة أدركه في شبابه كان يحسب بالنجوم في “مسجد الحساب” لـ”فلج بومنخرين” واسمه منصور بن سيف المعمري بأنه كان يحفظ من تاريخ البلد ويعرف من شؤونها الكثير، يقول: فقلتُ لرجل ما معناه: ليت ما يحفظه منصور بن سيف يُكتَب، وإلا سيضيع، فرد علي: “ما حد متفيّق حال كذا”، وكأنه حين يحكي ذلكم الموقف يستشرف ما يحذره من ضياع التاريخ وفوات التوثيق، ولعل ذلك مما حدا به إلى توثيق الأفلاج من حصص وقواعد وسنن، وحصر أموال أوقاف المساجد، وهو مما سيسجله له التاريخ من أعمال جليلة باقية، بل إنه حري بنا هنا أن نعده آخر من اشتغل بالتوثيق في بلدنا، وآخر من يرجع إليه الناس في توثيق الذاكرة القديمة، فهو آخر الواقفين على ثغور الذاكرة.
حتى السنة الأخيرة من حياة المعلم حمود كان الوافدون إليه لا ينفكّون بين من يسأل عن ماء فلج أو أصل ضاحية أو رمّ، أو من يطلب شهادة على تملّك، هذا فضلًا عما أسداه إلى الناس وقضاه لهم من حوائج من مثل عقد الزواج وقسمة المواريث والشهادات والصلح وغيرها، وهو بذلك ساكن بين أفئدتهم، خالد في ذاكرتهم. رحمه الله وغفر له وأكرم مثواه.