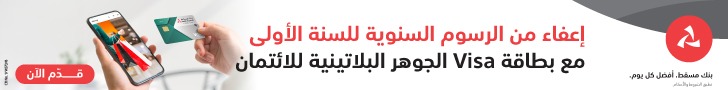القول الفصل في الرد على مزاعم المغرضين.. (عُمان وشرق أفريقيا)

بقلم ناصر بن عبدالله الريامي
مؤلف كتاب (زنجبار: شخصيات وأحداث)
عندما نسمع من جاهلٍ؛ أو نقرأ لمختلٍّ عقليًا، يُطلق خُزعبلاتٍ بشأنِ أمرٍ ما؛ فلاشك أن ردة الفعل الهادئة والعقلانية، ينبغي ألا تحيد عن المنهج الرباني، المستخلص من سورة الفرقان: “وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا”. فلاشك أن مُقارعة الجاهل بالحُجَج والبراهين، مُجاراةٌ له فيما هو فيه.
وفي خصوصيةِ الموضوع الماثل، فلقد طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي، في غضون الأسبوعين المنصرمين، خُزعبلات بلهاء، كتبها أحد الجاهلين بالحقائق التاريخية، انصبت على الطبيعة التي كان عليها الوجود العُماني في المشرقِ الأفريقيّ، مُؤكّدًا – شفاهُ الله – أنها كانت ذات طبيعة استعمارية. ثم يتمادى في أباطيله المستطرفة، إلى إضافة ذلك العنصر الخُرافيّ الذي تهواه النفوس والأقلامُ الغربية المُضلّلة، المتعلق بالرق عامة؛ وبالاتجار به، خاصةً؛ دعمًا لمصالح استعماريةٍ عنصرية دينية معروفة. يستطرد ضيفنا في ترّهاته، وفي أباطيله المغرضة غالبًا – سامحه الله – فيقول أن ما فعلته “سلطنة عُمان” في زنجبار، إنما هو أسوأ مما فعلته الصهيونية في فلسطين المحتلة!!
لم تنتهِ الخزعبلات الماثلة عند هذا الحد، وإنما تمادى فيها أخونا في الله، ليصف ذلك العُدوان الدَّمويّ الغاشم، الذي وقع على زنجبار ومواطنيها في يناير 1964م، بالـ”ثورة”؛ إضفاءً للمشروعية. وينتهي في هذا الجانب، فيضفي تحليله الاجتماعي فيقول: إن تلك “الثورة” كانت نتيجةً طبيعيةً وحتميةً للمعاملة العُمانية البربرية للسُّكان الأصليين في أرخبيل زنجبار.
وفق الإشارة المتقدمة، فإن صدور مثل هذه الأساطير الواهية والمضحكة من جاهلٍ أو مُختل، تدعو إلى التزام الصمت المجرّد؛ أما وكونها صادرة ممَّن ينسب نفسه إلى فئة المتعلمين، ويزعم – تعديًا في الغالب – أنه “متخصص في الشؤون الدولية والاستراتيجية، وفي الشؤون الأفريقية والشرق أوسطية”، وفي جامعة مُحترمة ومرموقة؛ فالأمر يتطلب الوقوف قليلًا، ليس للرد عليه، فهو غير جدير لذلك، لما سبق بيانه؛ وإنما، خوفًا من أن يتأثر بمراكزه المزعومة تلك، “قليل العلم” من جمهور العامة، فيصدقوا مقاله.
لعل المضحك في هذه التُرهات – وإن كانت هي كذلك في عمومها – أن صاحبها أقحم دولة، لا شأن لها بما حدث في زنجبار، وأسند إليها أحط الصفات الاستعمارية؛ بعد أن صور الحراك الذي أطاح بالشرعية قائلًا، أنه كان: “ثورة أصحاب الأرض، حررتهم من المستعمرين المحتلين تجّار البشر والنخّاسين من سلطنة عمّان الاستعمارية”. من حق القارئ هنا أن يتساءل عن سبب إقحام “سلطنة عُمان” في عُدوان وقع في سلطنة زنجبار، وهي لا تشترك معها في الجغرافيا؛ وإن اشتركت معها في تاريخٍ قديم. هل غفل أن زنجبار كانت قد انفصلت عن الدولة العُمانية لما يربو على المائة عام، قبل أحداث 1964م؟؟ وهل تقبل مثل هذه الغفلة، مِمّن يَزعم بأنه مُتخصص في الشؤون الإفريقية .. أم أن اتهامه قائم على دوافع شخصية، لا يستطيع الإفصاح عنها!؟ أترك الإجابة لتقديرات الجمهور.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن من أبجديات التخصُّص في شأن منطقةٍ ما، العلم بأسماء الدول، الواقعة في منطقة التخصُّص؛ وهو ما أخفق فيه من يزعم بأنه خبير في شؤون الشرق الأوسط، حيث فاتته حقيقة أن الدولة العُمانية لم تُعرف أساسًا باسم “سلطنة عُمان”، إلّا في سنة 1970م. أم أن صفة الخبير هنا، ألصقها لنفسه أيضًا دون وجه حق!؟ عمومًا، نقول أنه، وعلى افتراض إصابته في استخدام الاسم الصحيح للدولة في تلك الفترة؛ هل يُعقل أن تتدخل دولة ما في استعبادِ شعبٍ، والتنكيل، والمتاجرة بهم، وهم ليسوا من العناصر المكونة لإقليمها، ولا سلطان لها عليهم!! أيضًا، أترك الإجابة لحكم العقل والمنطق، والتقدير السليم للأمور.
كما أن اللافت للنظر، أن “خبيرنا في الشأن الأفريقي”، لم تدفعه إنسانيته المزعومة، إلى اتهامِ الدول الغربية، التي سبق لها استعمار زنجبار؛ غالبًا تنزيهًا لها عن الممارسات اللاإنسانية؛ رغمًا عن ثبوت تنكيلها بأهل الأرض. شخصيًا، أُرجِّح أن يكون “المستأجرون لقلمه” الضعيف، شكلًا ومضمونًا، هم المنزهون لها، ويرون فيها النقاء والكمال والقدوة .. وهم الذين يرون، تحقيقًا لأجندتهم السياسية المكشوفة، تلطيخ سمعة الدولة العمانية، من خلال إلصاق مسؤولية نقل ملايين من المستضعفين من السواحيليين، والأفارقة عمومًا إلى بعض دول العالم الغربي كعبيد، ومنها كندا والأمريكتين، فيما عُرف بـ”تجارة الرقيق عبر الأطلسي”، التي بدأتها أسبانيا والبرتغال، ثم نافسهما البريطانيون، والهولنديون، والبلجيك، والدنماركيون، والألمان، والفرنسيون، والسويديون. مورست هذه التجارة بفجاجةٍ وبشاعة، بعيدةً كلِّ البُعد عن أبسط مبادئ الإنسانية، عبر ما عُرف بالـ”مثلث العظيم”، أو (The Great Triangle). تجنبًا للإطالة، فلن أوضح للجمهور الكريم الدول الغربية المكونة لكل ضلعٍ من أضلع المثلث؛ ومع ذلك، فليس أقل من أن أشير إلى أنه، لم يكن لسلطنة عُمان، ولا لأيٍّ من دول الخليج العربية، أيّ ضلعٍ في تكوين مثلث العار هذا؛ وإنما كانت للدول التي يحلو لأمثال خبيرنا في الشؤون الأفريقية تتويجها بتيجان التحضُّر والإنسانيةِ والرحمة؛ علَّه يظفر برضاها.
وفي الوقت الذي لا أحاشي فيه أي دولة من دول العالم من أن تكون قد تعاملت تاريخيًا بالرقيق، بل وبالاتجار فيه أيضًا، لشيوع الظاهرة عالميًا آنئذٍ؛ أقول لمن يزعم أن “ملايين” من الرّقيق تم شحنهم إلى عُمان من المشرق الأفريقي: إذا صدق هذا الزعم، فالسؤال الذي يفرض نفسه، والذي يُردده البروفسور إبراهيم بن نور البكري، في كثيرٍ من محاضراته، نقلًا عن البروفسور الأمين بن علي المزروعي، الذائع الصيت عالميًا، هو: “إن صحت تلك المقولة، أين تلك الملايين اليوم، ولماذا لم يتجاوز عدد سكان عُمان، من المواطنين، عن الثلاثة ملايين؟ أين تلك الملايين التي يتشدق بها أصحاب الأجندات الخاصة؟ هل ابتلعتهم الأرض؟
يقول خبيرنا المحترم أيضًا، بما في معناه: أن العمانيين يُسوغون دخولهم زنجبار بذريعة نشر الإسلام؛ في الوقت الذي يؤكد لنا التاريخ بأن الإسلام دخل زنجبار عبر بوابة الحبشة. لا أعرف حقيقةً من أين أتى موضوعنا بهذا الافتراء. ليته أشار إلى المرجع العماني “الموثوق فيه” الذي ورد فيه هذا الزعم. فلا يجادل عاقل في هذه الحقيقة الثابتة.
ومع ذلك، ومراعاةً للأمانة العلمية، ليته أشار إلى من ساهم، وبفاعلية كبرى، في نشر الإسلام في المشرق الأفريقي. فالحقيقة الثابتة في كتب التاريخ تشير إلى أن الدور الأعظم في نشر الإسلام في تلك البقاع، كان على يد السلطان سعيد بن سلطان (1804 – 1856)، خاصةً عقب أن اتخذ من زنجبار عاصمةً لدولته، في سنة 1832م. فإذا كان الثابت يشير إلى أن الإسلام وصل إلى المشرق الأفريقي، حسب الإشارة المتقدمة، عبر بوابة الحبشة، فالثابت أيضًا، يشير إلى انتشاره إلى داخلية القارة في عهد السلطان سعيد، عبر حركة القوافل التجارية، من زنجبار، إلى عمق البر الأفريقي (أنظر: تاريخ مسلمي تنزانيا المعاصر، أ.د. يونس عبدلي، د. صالح محروس، 2022م).
وعندما نتحدث عن مسألة انتشار الإسلام عبر القوافل التجارية، لا ينبغي أن نغفل دور التاجر العماني، الشيخ أحمد بن إبراهيم العامري، الذي يرجع إليه الفضل في دخول الإسلام إلى أوغندا، في سنة 1843م. يستفاد ذلك من مذكرات أمين باشا، التي أورد فيها تفصيلات وصول العامري لبلاط “الكباكا سونا”، الملك سونا، وكيف استطاع بثباته وبرباطة جأشه، وبقوة حجته أن يرد الكباكا عن تلك العادة الوثنية المتمثلة في ذبح الأبرياء من رعيته قربانًا للآلهة؛ وكيف تطور ذلك إلى اعتناق الكباكا الإسلام، بعد أن واضب العامري على تعليمه المنهج القرآني في علاقة الحاكم بالرعية، وعلاقة السيد بالمسود؛ ليستتبع ذلك اعتناق أهل أوغندا الإسلام؛ بل، وإلى إعتماد التقويم الهجري، في وقتٍ لاحق.
ولعل من أهم ما قيلَ عن دور العُمانيين في نشرِ الإسلام في الكونغو، أنهم فعلوا ذلك أثناء نشاطهم التجاري، وأنهم: “لم يستخدموا ضغطًا سياسيًّا ولا قهرًا على المواطنين، ولم يفرضوا عليهم حضارتهم ولا دينهم، كما أنهم لم يُعاملوهم بتكبُّرٍ ولا باستعلاء؛ ليتحقق لهم – وبشكلٍ سلميّ – كسبًا دينيًا بجانب كسبهم الاقتصادي. كما لاحظ شعب الكونغو أمانة العمانيين في المعاملات التجارية؛ ناهيك عن ابتعادهم عن التّعصّب العرقيّ، وهي كلها عناصر ساهمت في إعتناقهم للإسلام (أنظر: أ.د. إبراهيم صغيرون، “الإسهام العماني في المجالات الثقافية والفكرية، والكشف عن مجاهل القارة الإفريقية”، والذي شارك به في ندوة “العمانيون ودورهم الحضاري في شرق إفريقيا”، المنتدى الأدبي، 1993م). هذه الشهادات تدحض ما زعم به خبيرنا، في الشؤون الأفريقية، حول مسألة فرض العمانيون الإسلام على الشعب الزنجباري عنوة وبحد السيف.
أما عن الأساطيرِ والرواياتِ الكاذبة، التي تدور في فلك معاملة العرب اللاإنسانية للرقيق في زنجبار، فلعل من أفضل ما يمكن الاستشهاد به لدحضها، تلك الحقيقة التي أطلقها الدكتور هولينجزورث، كالسهام في صدور أعداء الإسلام؛ فقال: أن كثيرًا من الرقيق لم يستحسنوا المرسوم السُّلطاني الذي قضى بإعتاقِهم من أسيادهم، وذلك نظرًا للمعاملة الحسنة التي كانوا يتلقونها في بيوتِ ومزارعِ أسيادهم العرب. وهي حقيقة أكّدها أحد أعضاء وكالة إلغاء الرّق، بشكلٍ رسمي، في أحد التقارير التي رفعها حول مسألةِ تنفيذ المرسوم السلطاني، إذ أشار إلى أن هناك الكثير من العبيد طلبوا إعادتهم إلى كنفِ أسيادِهم (أي إلى العبودية)، بعد أن تم تحريرهم؛ وعندما رُفِضت طلباتهم، نظرًا لعدم إجازة المرسوم السلطاني ذلك، أعربوا عن سُخطِهم وعدم ارتياحهم (أنظر: Zanzibar under the Foreign office, p. 154)
يقول هولينجزورث كذلك: إن أغلب العتقاء الذين عملوا بالأجرِ لدى الأوروبيين في زنجبار، بعد أن حرَّرهم النظامُ الجديد، رغمًا عنهم؛ آثروا العَودة للرق لدى أسيادهم السابقين من العرب؛ وذلك نظرًا للمعاملةِ اللاإنسانية التي تلقَونها من أسيادِهم الجدد (المرجع السابق، ص 159).
يؤكدُ المعنى المتقدم الدكتور بنيان تركي، فيقول: إنه لم يكن من الغريب أن يُسمعَ رقيق يتباهى أمام زملائه لكونِه مملوكًا لأحدٍ من ذوي المكانةِ الرفيعةِ في المجتمع. لذلك، فلم يكُن من الغريبِ أيضًا، ألّا يتقدم سوى أعداد جدّ قليلة من رقيقِ الطبقةِ الأرستُقراطية العربية لطلب الحصول على حرِّيتهم، مقارنةً برقيقِ الطبقات الأخرى؛ ذلك لأن هؤلاء الأرِقاء كانوا قد اعتادوا على العيشِ مع سادتهم في المدينة، حيث تتوفَّر لهم مُتطلبات المعيشة، من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ ومسكن، وهي امتيازات تفوق بكثير ميزة “الحرية”، التي كانت تعني بالنسبة لهم، جُل معاني الشقاء والعناء (أنظر: تركي، إلغاء الصفة القانونية للرق في سلطنة زنجبار). ومن الطريف الذي يُعزِّز هذا المعنى، ما أشار إليه (Lyne) في كتابه، حيث قال: إن من التهديدات المُجدية التي كانت تلجأ إليها الإدارة الزنجبارية ضد الأرقاء الكُسالى وعديمي الفائدة، تهديدهم بالعتق (أنظر: Zanzibar in Contemporary times, 1905, p. 187)
كما كتب الرَّحالة الأوروبي (Ritchard) عندما زار زنجبار عام 1880م، أنه لم يرَ رقيقًا يشكو من المجاعة أو التعذيب؛ ذلك لأنه إذا ما وصل خبرٌ، يحمل في طيَّاته أي نوعٍ من سوءِ المعاملة إلى السلطان، يعمل الأخير فورًا على إعتاقه، وضمان سلامته. يستمر الرّحالة في وصف حالة الرقيق في زنجبار فيقول: إنه وجد الرقيق في وضعٍ أفضل من آلاف العاملين في بلاده (المعمري، أحمد حمود، عُمان وشرق أفريقيا، ص 80).
أما عن الزعم زورًا وبهتانًا بأن التاريخ العُماني غير مشرف في المشرق الأفريقي، وأن ذلك لم يكن بسبب معاملة العمانيين الوحشية والعنصرية للجنس الأفريقي فحسب؛ وإنما، بسبب تعاونهم مع المستعمرين الغربيين في التنكيل بتلك الفئات المستضعفة. أنقل لكم، ردًا على هذا البهتان، ما قاله جرانفيل، وهو وزير دولة في أول حكومة وطنية في الكونغو بعد الاستقلال، حيث قال:
“لقد زوّر البلجيكيون كل شيء في الكونغو. فليس العرب المسلمين، كما أوهمونا، تُجّار رقيق؛ وإنّما، تلك الموجة الإنسانية التي اختلطت بنا وصاهرتنا، وتركوا لنا على أرضنا دماءهم، والبلجيكيّون يحصدونهم بالأسلحة الحديثة، وليس أعزّ علينا شيء سوى هذا الدّم العربي الذي سال في الماضي، كما سال ويسيلُ دمنا الآن على أرضنا .. وعلى أيدي أعداء العرب نفسهم في القرن الماضي ….” (دياب، أحمد إبراهيم، لمحات من التاريخ الأفريقي الحديث، ص 82).
كما أن الثابت تاريخيًا يشير إلى أن العمانيين وقفوا بجانب إخوانهم من العرق الأفريقي صفًا كفاحيًا واحدًا، ضد المستعمر الغربي. ثمة مواقف كثيرة تؤكّد هذا المعنى، عصية هي عن الحصر؛ ومع ذلك، فلا أقل من الإستشهاد بتلك الحرب الضروس التي شنّها الشهيد، بإذن الله تعالى، الشيخ بشير بن سالم البرواني الحارثي الذي رفع راية الجهاد في أواخر القرن التاسع عشر، ضد المستعمر الألماني في مقاطعة تانجا، في دولة تنجانيقا، بعد أن تجاوزت غطرسته على جمهور العامة. وعلى الرغم من النتائج العسكرية الإيجابية التي حققها جيش الحارثي في هذه الحرب، والتي أدت إلى تقهقر وتضعضع الجيش الألماني؛ إلا أن حصول الأخير على قوة إسناد بريطانية قوية، أدى إلى هزيمة القوات الوطنية (العربية الأفريقية)، وإلقاء القبض على المجاهد بشير البرواني، وأعدم في ميدان عام بتاريخ 15 ديسمبر 1889م (البرواني، علي محسن، الصراع والوئام في زنجبار).
كما لا ينبغي، في هذا المقام، أن نتجاوز عن دور المجاهد العماني محمد بن خلفان البرواني، الذي أنقذ قبيلة الوَهيهي (Wahehe) التنجانيقية من المدافع الألمانية بشجاعته وبسالته وإقدامِه (أنظر: الإسماعيلي، عيسى بن ناصر، التكالب الإستعماري على زنجبار، ص 30 – 31).
أخيرًا، وليس آخرًا، فإن الفيديو الذي أرفقه موضوعنا، لتأكيد الزعم المتعلق بالقبو الذي يقال زورًا بأن زنجبار استخدمته لتخزين الرقيق، قبل نقلهم، بطريقة لا إنسانية، إلى دول العالم؛ تدحضه الحقيقة المؤكّدة بأن القبو كان جزءًا من عيادةٍ طبية، التي شيدت في الأساس بعد إغلاق سوق الرقيق بسنينٍ طويلة؛ وأنه، أي القبو، لم يكن إلا مكان لتخزين الأدوية؛ لمناسبة الجو فيه لذلك. (أنظر: Jonathon Glassman, Racial Violence, Universal History and Echoes of Abolition in Twentieth Century Zanzibar (.
يخبرنا التاريخ أخيرًا، بأن أكبر مركزٍ لتجارة الرقيق، في المشرق الأفريقي، لم يكن في زنجبار، كما يحلو للمغرضين دائمًا العزف على هذا الوتر؛ وإنما كان في مستعمرة موزمبيق البرتغالية. يقول البروفسور إبراهيم البكري: إن هذا هو السبب وراء وجود أكثر من سبعين مليون نسمة من ذوي الأصول الأفريقية في البرازيل التي كانت مستعمرة برتغالية أيضًا. ويقول الشيخ عيسى الإسماعيلي: لم تقتصر تجارة الرقيق في زنجبار على العرب فحسب؛ وإنما، تقدَّمهم، من حيثُ الزمانِ والنطاق، الإنجليزُ والفرنسيون والهنود والشيرازيون، والكثيرُ من الشعوبِ الأوروبيةِ الأخرى. ويؤكد البكري أخيرًا: إن عملية اختطاف الضحايا، ما كانت لتتم لولا اشتراك بني جنسهم، من زعماء القبائل، تجار الرقيق.
وبجانب سوق الرقيق المشهور الذي كان في موزمبيق، فلقد تمركزت الأسواق الأخرى في تنجانيقا، التي كانت خاضعة للحكم الألماني ثم للحكم البريطاني، بعد الحرب العالمية الأولى؛ وفي كينيا أيضًا حتى سنة 1912م. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه التجارة البغيضة زاخرة في هذه الدول، تدرج الحظر الاتجار بالرقيق في زنجبار، قبل ذلك بسنين طويلة، ابتداءً من سنة 1822م، مرورًا بعام 1845م؛ إلى أن صدر مرسوم سلطاني، في عام 1897م، بإلغاء الصفة القانونية للرقيق نهائيًا، وتأكد عليه بمرسوم آخر في سنة 1890م. لا أحد يذكر حقيقة تقدم سلطنة زنجبار، على كثير من دول الجوار، في إلغاء نظام الرق؛ كما لا يذكر أحد أسواق الجوار التي ذاع صيتها، لأنها كانت ببساطة تحت إدارة الدول الأوروبية، التي لا تدين بالإسلام. فالقصد إذن، من وراء إقران اسم زنجبار بتجارة الرقيق، ليس طعنًا في زنجبار، بحد ذاتها، ولا في نظام حكمها السلطاني، ولا في العروبة؛ وإنما، طعن في الإسلام، دون سواه؛ فعلينا أن ننتبه دائمًا إلى هذه الحقيقة. (راجع: البكري، إبراهيم نور، الدعاية العقائدية في تنزانيا).
غير خافٍ على كل ذي بصيرة وإدراك، أن بريطانيا التي كانت أكثر دول العالم اتجارًا بالرقيق، لم ترفع راية مكافحة هذه التجارة، بعد أن شيدت مدنها الكبرى، خاصة بريستول وليفربول، مراعاة لحقوق ولحريات الإنسان، ولا بوازعٍ ديني، كما تزعم؛ وإنما لدواعٍ منبتة الصلة عن ذلك كله، منها اقتصادي محض، والمتمثل في تراجع الجدوى الاقتصادية لتلك التجارة بعد الثورة الصناعية، وتحوُّل المجتمع الأوروبي من مجتمعٍ زراعي بسيط إلى مجتمعٍ صِناعي، يعتمد على الميكَنة في الصناعة، وفي الزراعةِ أيضًا. كما أنها استغلت هذا الملف للتدخل السياسي في أفريقيا بشكلٍ عام.
وعليه، فإن جميع المعاهدات التي أبرمتها إنجلترا، سواءً مع سلاطين زنجبار، أو مع مصر الخديوية، بشأن إلغاء تجارة الرقيق، وتفتيش السفن في المحيط الهندي أو في البحر الأحمر وخليج عدن، لم تكن إلا جزءًا من مُخطّطٍ استعماري. (جلال يحيى، مصر الإفريقية، ص 186 – 187). أخيرًا، فلقد وجدَتها بريطانيا فُرصةً سانحةً لتجميل صورتها أمام الشعوبِ الأفريقية بادعائها الدفاع عن مصالحهم.
أنوه أخيرًا، بأن هذا الملف هو من أكثر الملفات التي استخدمت في بذر الكراهية في المجتمع الشرق أفريقي، المتعدد الأعراق، من خلال نسج الأكاذيب العرقية والطائفية، وعلاقتهما في استرقاق العرق السواحيلي؛ ثم استخدمت تلك الأكاذيب في الاستعانة بمرتزقة من خارج دولة زنجبار، لتنفيذ مذبحة عام 1964م، والتي عدت وبحق، من أسوأ مذابح القرن العشرين.
أقول لكل من يعشق تكرار العزف على وتر العرقية والطائفية، ولمن يحلو لهم إضافة عنصر المذهبية، كما فعل خبيرنا: هل أغاظكم منهج القيادة العمانية في مد يد الصداقة إلى دول المشرق الأفريقي، وترون – بدلاً من ذلك – إذكاء الكراهية، بسبب ما حدث في الماضي؛ وتسعون، تبعًا لذلك، إلى إحراق الحرث والنسل، وتدمير النسيج المجتمعي المتعدد الأعراق من جديد؟
أستغل هذه السانحة أخيرًا، لأدعو أولئك الذين تسكن عقولهم مفاهيم مغلوطة، الابتعاد عن قراءة المؤلفات التي تأثرت بالنهج الاستعماري، سواءً كان كتابها عربًا أو غير عرب. ولإستيعاب الحقائق وفهمها فهمًا دقيقًا، أدعوهم لقراءة المؤلفات التالية: الصراع والوئام في زنجبار، لعلي بن محسن البرواني؛ زنجبار: التكالب الاستعماري، وتجارة الرقيق، لعيسى بن ناصر الاسماعيلي؛ الدعاية العقائدية في تنزانيا، للبروفسور إبراهيم بن نور البكري؛ وداعًا الاستعمار، وداعًا الحرية، للدكتور حارث الغساني؛ التنصير في شرق أفريقيا، للبروفسور يونس عبدلي، والدكتور صالح محروس؛ أخيرًا وليس آخرًا، زنجبار: شخصيات وأحداث، لناصر الريامي. هي كتب تاريخية، بعيدة عن القول المرسل، والإطلاقات اللفظية؛ ومرتكزة على حقائق تاريخية ثابتة وقاطعة، غير قابلة للتفسير والتأويل المغايران للحقيقة، والله من وراء القصد.