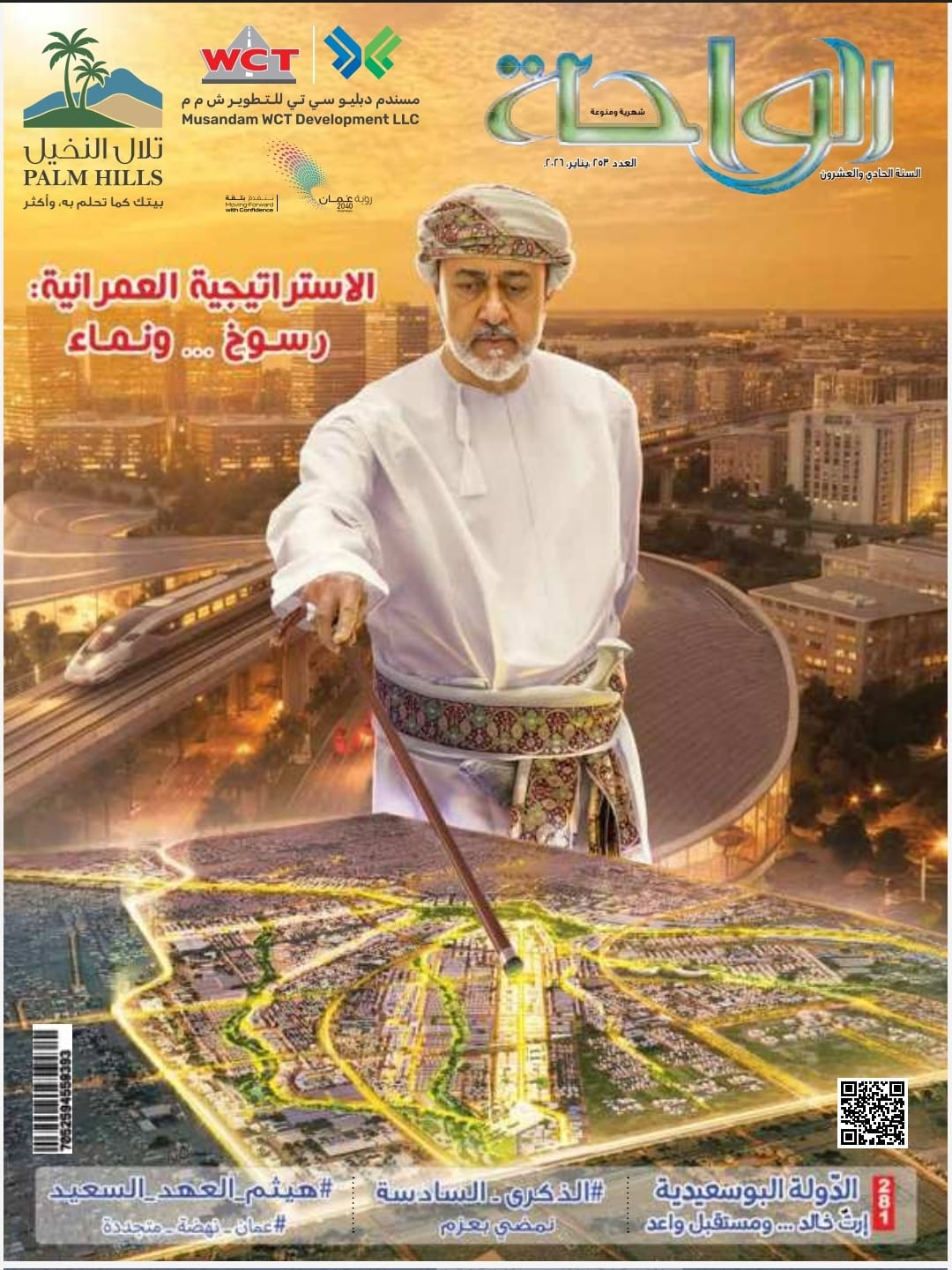لو كان محمود درويش حيّاً اليوم؟ ماذا يمكن أن يكتب؟

بقلم: سيلينا السعيد
لو كان محمود درويش حيّاً اليوم، لكان يجلس في زاوية مقهى يطلّ على البحر الحالم، أيّ بحر؟ شاطئ بحر يحتضنه في لبنان أو سوريا أو مصر ، لا فرق ، يرتشف قهوته العربية المُرّة و دخان سيجارته يحرق الكلمات.
يهمس للأمواج الهائجة بحذر كأنه يخشى أن يوقظ الكلمات النائمة في صدره.يضرب الموج الصخور و يدندن لحن ” و تكبر فيّ الطفولة يوماً ….
ويتساءل: هل ما زالت الأرض تضيق بأحلام أهلها؟ هل ما زال الوطن يُعشعشُ في الذاكرة كقصيدةٍ أبَتْ أن تكتمل؟
ربما كان سيكتب عن طفل على شاطئ غزة يطير بطائرته الورقية فوق الأنقاض، يرسل رسائل سماويّة حُرة لا تعرف الحدود،
أو يكتب عن امرأة بلونِ القمح و الزعتر تنسج أملاً هارباً في خيط تطريز، عن شجرة زيتون عتيقة ما زالت تذكر أسماء من عبروا تحت ظلّها. كان سيكتب عن وطن صار خريطة في جيب المنفى، وعن المنفى الذي صار وطناً ضيقًا كحقيبة سفر.
أو ربما كان سيُكمل قصيدة هاربة من دفتره، أو بيت شعرٍ تمّرد في حقيبة سفره، أو ربما زاد سطراً على المّارين عبر قصائده،
أيها المارُّون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، و انصرفوا وخذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة و خذوا ما شئتم من صورٍ كي تعرفوا أنَّكم لن تعرفوا كيف يبني حجرٌ من أرضنا سقف السماءْ…
لو كان محمود درويش حيًّا، لربما سأل العالم: كم مرّة يجب أن نموت لنثبت أننا أحياء؟ كم مرة يجب أن نكتب لنُقرأ، وكم مرة يجب أن نُقرأ لنُفهم؟
ربما كان سيجلس في غرفته ليلاً، يسجّل أنا عربي ، يهمس إلى الضوء المتسلل من الشباك الماطر ، ويتنهد: “أنا لستُ لي.. أنا للشعر وللحكايات التي لم تُروَ بعد.” ثم يأخذ قلمه، ويكتب:
“على هذه الأرض ما يستحق الحياة”
ثم يتوقف، يتأمل، ويهمس للسراج المتوهج : “لكن، هل ما زالت الأرض تذكرني؟”