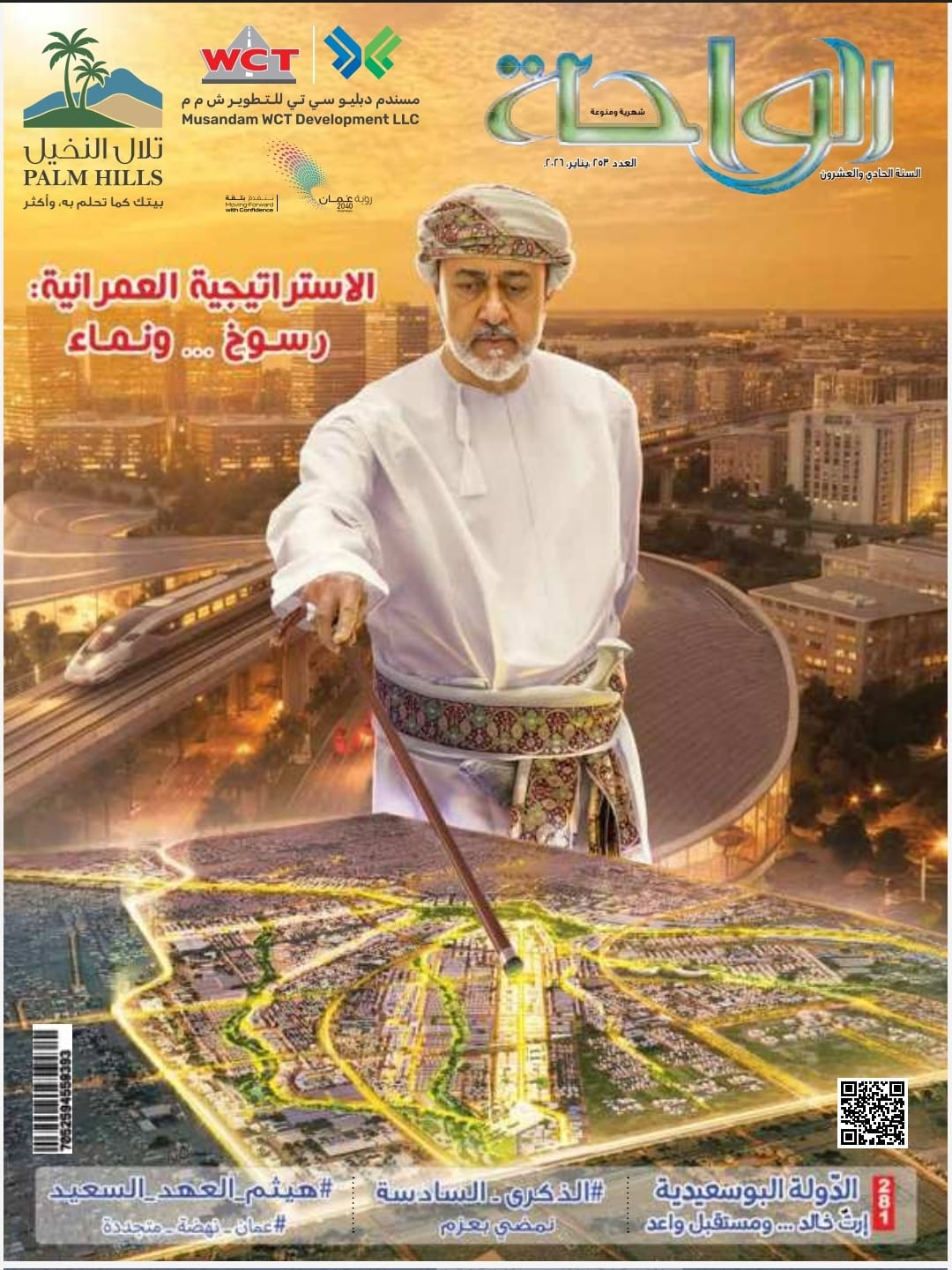المنعطف الحاسم… أمتنا بين الوحدة والسقوط

المنعطف الحاسم… أمتنا بين الوحدة والسقوط
محمد بن علي البادي
في هذا الزمن المضطرب، نقف كأمة إسلامية أمام منعطف تاريخي لا يحتمل التردد أو المجاملة.
إما أن نعي خطورة المرحلة، ونتوحد صفًا واحدًا في وجه الأطماع الخارجية، أو نُترك فرادى نُستنزف، ونُستخدم، ثم نُلقى جانبًا كما تُلقى الأوراق بعد أن تُستهلك.
ما نشهده من تحالفات مريبة، وتدخلات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وتحكم خارجي في قرارات مفصلية لبعض دولنا، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمشروع تفتيت ممنهج، لا يستهدف الأرض فقط، بل الإنسان والهوية والسيادة.
كلما سقطت دولة إسلامية، ظن البعض أن الخطر قد ابتعد عنه، لكنه في الحقيقة اقترب أكثر.
سقوط العراق لم يكن نهاية، بل كان بداية. وسقوط ليبيا وسوريا لم يكن صدفة، بل كان درسًا لغيرهم: من لا يتعلم من مصير غيره، سيدفع الثمن من نفسه.
لقد كانت الأمة العربية – رغم ما مرّت به من أزمات – قادرة على الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك السياسي.
وإذا ما خرجت دولة عن الإجماع، كانت بقية الدول تقف صفًا واحدًا لإعادتها إلى البيت العربي، لا عن عداوة، بل عن حرص ومسؤولية جماعية.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث عندما وقّعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل.
يومها غضب العرب، واتُّخذ قرار بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، لكن ذلك الغضب لم يتحول إلى قطيعة أبدية.
بل كان مجرد تعبير عن موقف سياسي جماعي أراد حماية الثوابت، لا تمزيق الصف.
وبفضل حكماء الأمة في ذلك الوقت، وعلى رأسهم قادة عرب عقلاء، طُوي الخلاف، وعادت مصر إلى أحضان أمتها.
هكذا كانت العلاقات العربية. فيها خلافات، نعم، لكنها لم تكن تقطع ما بيننا من روابط الدم والدين والمصير المشترك.
أما اليوم، وللأسف الشديد، فقد تحول الخلاف إلى خصومة، والخصومة إلى قطيعة، والقطيعة إلى اصطفاف مؤذٍ ومكلف.
كمواطن عربي لا يملك إلا الكلمة، أرى أن كثيرًا من هذه الخلافات لا ترقى لأن تكون مبررًا للعداء، ولا تبرر تمزيق البيت العربي بهذه الصورة.
فما بيننا أكبر من أن يُختزل في ملفات سياسية عابرة، أو تصريحات إعلامية انفعالية، أو وساطات تُقبل من الأجنبي وتُرفض من القريب.
لكن هذا الشرخ العربي لم يتوقف عند العلاقات البينية بين الدول، بل تجاوزه ليؤثر بشكل مباشر على قضايانا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت – ولا تزال – مرآة صادقة لمدى تماسكنا أو تفرقنا.
فحين كان الصوت العربي موحّدًا، كانت فلسطين قضية الجميع، وكانت كلمتنا واحدة في المحافل الدولية، وكان العالم يحسب حسابًا لغضب العرب.
أما اليوم، فقد أصبحت فلسطين ملفًا يُدار على هامش المصالح الضيقة، أو تُستخدم كورقة تفاوض هنا وهناك.
اختلفنا في تصنيف الفصائل، واختلفنا في التوصيفات، ثم اختلفنا في المواقف، حتى باتت بعض العواصم العربية تتحدث عن “الطرفين المتنازعين”، وكأن الاحتلال الإسرائيلي مجرد طرف محايد في نزاع داخلي!
وما ذلك إلا نتيجة طبيعية لفقدان البوصلة، وتراجع الشعور بالانتماء الجمعي، والانشغال بخلافات هامشية جعلتنا نتخاصم مع من يشاركنا الدين والتاريخ والمصير.
وفي الحقيقة، فإن ضياع القضية الفلسطينية لم يكن بسبب إسرائيل وحدها، بل كان نتيجة مباشرة لحالة الشد والجذب، والانقسام، والصراع غير المبرر بين الدول العربية نفسها.
لقد تفرّقت المواقف، وتناقضت السياسات، وتباعدت الرؤى، حتى باتت بعض الدول تنظر إلى فلسطين كملف عبء، أو مجرد ورقة ضغط في صراعات جانبية، بدل أن تكون القضية المركزية التي توحد الصفوف وتُعيد ترتيب الأولويات.
نحن بحاجة ماسّة لإعادة ترتيب أولوياتنا، ليس فقط دعمًا لفلسطين، بل دفاعًا عن أنفسنا قبل أن نُفاجأ بأن الدور قد وصل إلينا.
فالتاريخ لا يرحم، والأعداء لا ينتظرون، ومن يظن أنه بمنأى عن الخطر لأنه يلتزم الصمت أو الحياد، فليتأمل مصير من سبقوه.
لقد آن الأوان أن نُراجع أنفسنا بصدق، ونتجرّد من الحسابات الضيقة، وندرك أن وحدة الأمة لم تعد رفاهية سياسية، بل ضرورة بقاء.
فالمتغيرات الدولية لا ترحم، والتحديات تتعاظم، ودوائر الاستهداف تتسع، ومن لا يملك اليوم قرار التوحد، سيُجبر غدًا على قرار الالتحاق مكرهًا أو الخضوع مذلًّا.
إننا نُوجّه هذه الرسالة – بكل محبة وصدق – إلى قادة الدول العربية:
عودوا إلى بعضكم، وضعوا خلافاتكم على طاولة العقلاء، لا على موائد الغرباء.
افتحوا أبواب المصالحة، ولو كانت الكلفة كبيرة، فثمن القطيعة أكبر وأخطر.
تذكّروا أن التاريخ لن يرحم، والأجيال لن تنسى، والشعوب لا تموت، مهما أُنهكت.
وفي الوقت ذاته، فإننا لا نعفي الشعوب من المسؤولية.
فلكل فرد في هذا الوطن العربي الكبير دور في دعم كل نداء للوحدة، ونبذ كل دعوة للتفرقة، وكشف كل مخطط يُراد به تمزيق الصف وتشويه الرموز وإثارة الفتن.
وحدة الأمة تبدأ من وعي الإنسان البسيط،
ثم ترتقي إلى صانع القرار،
ثم تتحول إلى موقف جماعي يعيد للأمة اعتبارها وهيبتها.
ما زالت الفرصة قائمة، وما زال الأمل حاضرًا، ولكن الزمن لا ينتظر.